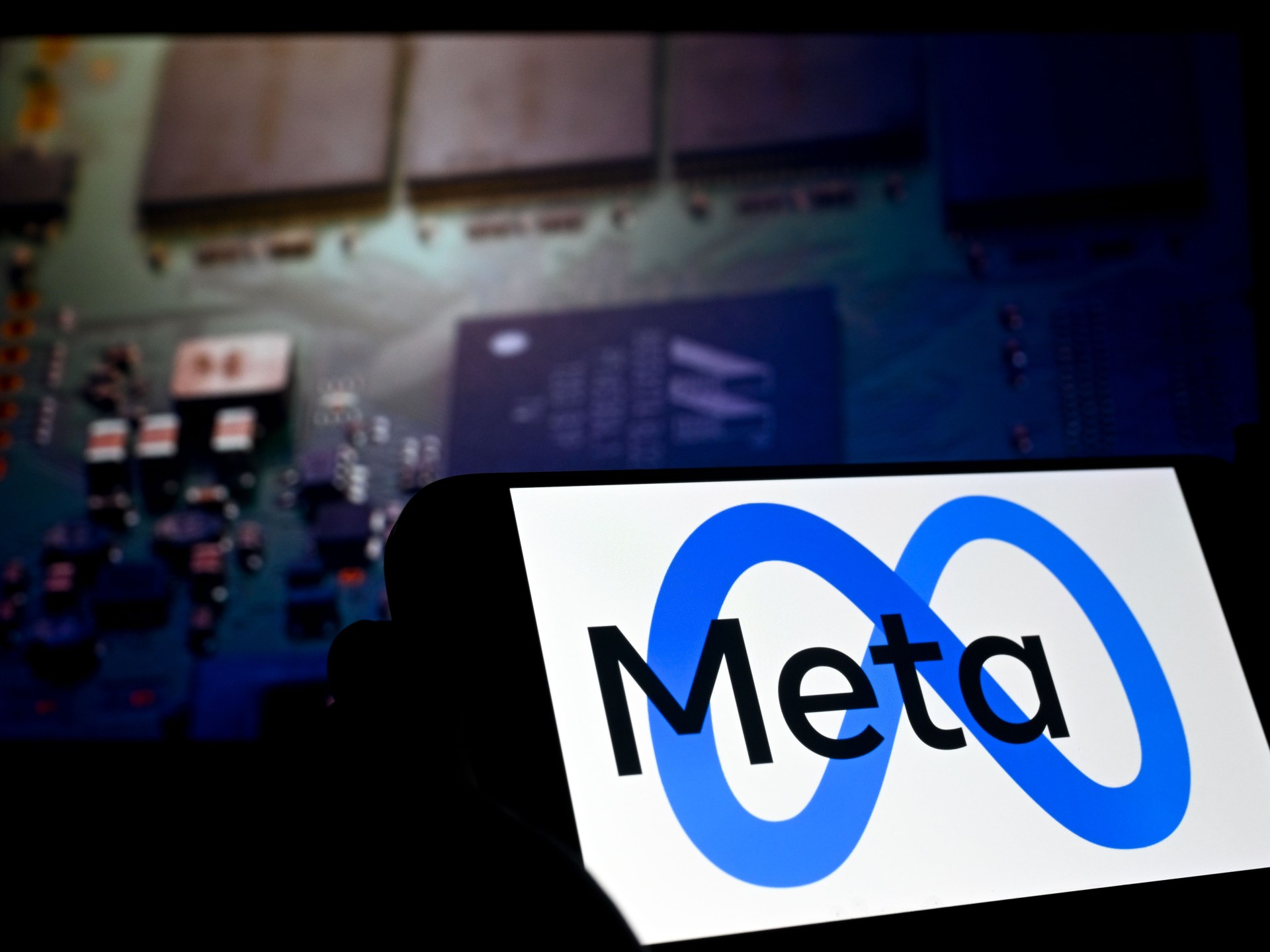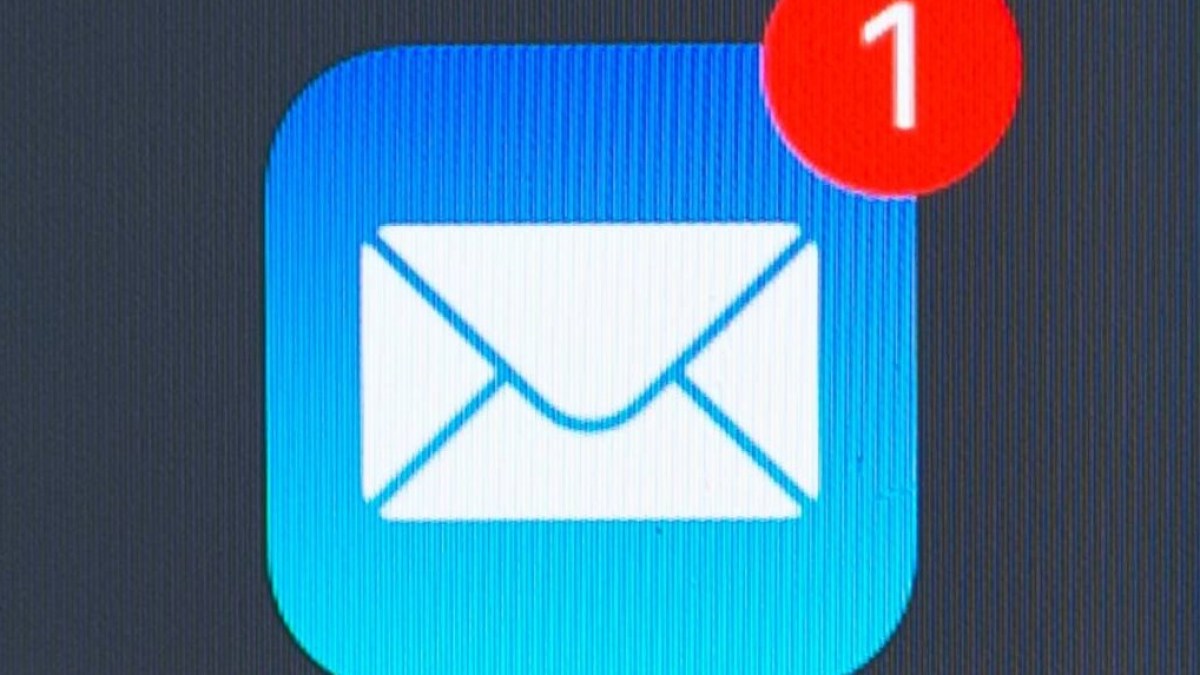ومن هنا، تبرز أهمية تحديد الأولويات لكل أقلية على حدة؛ وذلك لأنها خطوة أساسية في توجيه الأقليات المسلمة نحو الاستقرار والأمان، اللذين يؤديان إلى تحسين أوضاعها، وتمكينها من الاندماج الإيجابي في المجتمعات الصديقة، بما يحفظ خصوصيتها الدينية والثقافية.
إن فقه الأولويات يعتبر من المفاهيم الأساسية التي ينبغي الإلمام بها، واستيعاب مفاهيمها الشاملة في ضوء القرآن والسنة ويعرَّف بأنه وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، من غير تقديم لما حقه التأخير، ولا تأخير لما حقه التقديم
يُعتبر المسلم دومًا جزءًا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، وذلك انطلاقًا من رابطة الأخوّة الإسلامية المتجذّرة في العقيدة الإسلامية.
وتؤكّد النصوص القرآنية هذا الانتماء العميق المتجذر؛ قال الله تعالى: {إنَّما المؤمنون إخوةٌ}، وقال أيضًا: {إنَّ هذه أمَّتكم أمَّةً واحدةً وأنا ربُّكم فاعبدونِ}، وهذان النصّان يرسّخان هذه القاعدة الإيمانية العميقة في وجدان كل مسلم.
بيد أن الواقع الجغرافي والسياسي يشهد انتشار المسلمين في أنحاء مختلفة من العالم، بحيث لا يعيش جميعهم ضمن كيانٍ سياسي موحّد أو حتى ضمن دول إسلامية؛ فقد أصبح وجود مجموعات من الأمة الإسلامية في دول غير إسلامية أمرًا حتمًا واقعًا يجب الاعتراف به، وكانت وراء ذلك أسباب وعوامل تاريخية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية وتعليمية.
ومن هنا كان من الضروري أن نتعامل مع هذا الواقع الموجود بوعي عميق ومعرفة تامة بظروف المسلمين المتعددة في تلك البيئات. والهدف الأساسي من ذلك هو المحافظة على هويتهم الدينية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في حدود الأطر القانونية والوطنية التي ينتمون إليها.
وإن وجود المسلم في بيئة يَغلُب عليها غير المسلمين يقتضي منه ترتيب أولوياته وفق مقتضيات وضعه الخاص، مع التزامه بثوابت دينه وتعاليم شريعته.
وإن فقه الأولويات يعتبر من المفاهيم الأساسية التي ينبغي الإلمام بها، واستيعاب مفاهيمها الشاملة في ضوء القرآن والسنة. ويعرَّف بأنه “وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، من غير تقديم لما حقه التأخير، ولا تأخير لما حقه التقديم، ومن غير تهوين لما هو عظيم، ولا تعظيم لما هو هين”. ويحقق هذا الفقه التوازن بين الثوابت والمتغيرات، وتقديم الأهم على المهم، ومن شأنه تمكين المسلم من المحافظة على دينه وهويته، والمساهمة الإيجابية في المجتمع الذي يعيش فيه، من غير تنازل عن المبادئ، ولا انغلاق يمنعه من التفاعل البنّاء مع محيطه.
لم تعد “ديار الإسلام” و”ديار الكفر” مفاهيم تُطبق بحرفيتها كما في العصور السابقة، بل أصبحت الدول الحديثة كيانات مدنية قائمة على المواطنة والقانون، مع تفاوت في مساحة الحرية الدينية
انتماء الأقليات المسلمة
كون الأقليات المسلمة جزءًا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية الكبرى، فإنما يكون بتمسكها بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وأدائها واجباتها الدينية، واعتزازها بانتمائها الإيماني؛ فمناط الانتماء في الإسلام لا يرتبط بالجغرافيا أو السياسة أو الجنسيات، وإنما ينبني على رابطة العقيدة التي هي أعمق وأبقى من الأسباب الدنيوية.
وقد قرر الفقهاء أن رابطة الإيمان هي الرابطة الأساسية في الإسلام، وقوله تعالى: {إنَّما المؤمنون إخوةٌ} خطاب عام يشمل جميع المؤمنين في أي مكان وزمان.
أما حمل هذه الأقليات المسلمة جنسيات دول غير إسلامية، أو إقامتها دومًا في بلدان غير مسلمة، فلا يُخرجها من دائرة الأمة الإسلامية، والمحافظة على هُويتها الإسلامية هي المعيار المعتبر.
وهذا الانتماء الإيماني يقتضي من الأمة الإسلامية الكبرى الوعي بمسؤولياتها تجاه هذه الأقليات، والعمل على دعمها وحمايتها ماديًّا ومعنويًّا، وبخاصة في ظل الأزمات والاضطهادات.
وفي المقابل، هناك مسؤوليات على الأقليات المسلمة تجاه الأمة الإسلامية أيضًا، من أهمها الحفاظ على صورة الإسلام، وتمثيل القيم الإسلامية في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية، والسعي لبناء جسور التفاهم والحوار الحضاري.
كما أن عليهم واجب دعم قضايا الأمة العادلة، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين في الداخل والخارج، على أساس رابطة الأخوّة الإسلامية، التي لا تحدّها حدود سياسية أو قومية.
لقد تناول العلماء قديمًا وحديثًا مسألة انتماء الأقليات المسلمة للأمة الإسلامية، وتعدّدت آراؤهم ومذاهبهم في ضوء فهمهم للنصوص الشرعية، وظروف الواقع الذي تعيش فيه تلك الأقليات. ويمكن تصنيف هذه الآراء في اتجاهين رئيسين:
الاتجاه الأول يرى أن الأقليات المسلمة التي تقيم في ديار غير إسلامية بدون هجرة إلى ديار الإسلام لا تُعدّ منتمية فعليًّا إلى الأمة الإسلامية الكبرى، ولا تُقام بينها وبين سائر المسلمين رابطة الولاء الكامل، ويستند هذا الاتجاه إلى مفهوم الهجرة كشرط ضروري للموالاة والانتماء.
وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية، كالإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، وكذا الرازي، ويرى هذا من المفكرين المعاصرين سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، رحمهم الله جميعًا.
ويُفهم من هذا القول أن المسلم الذي يختار الإقامة الدائمة في ديار غير إسلامية مع وجود القدرة على الهجرة يُعدّ مقصرًا في واجبه تجاه المسلمين، ولا يستحق نفس أحكام الولاء الكامل.
والاتجاه الثاني يمثّله جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة، ويؤكد هذا الاتجاه على أن انتماء المسلم إلى الأمة لا يتوقف على موطنه أو جنسيته أو مكان إقامته، بل يقوم على رابطة العقيدة والإيمان، فالولاء قائم لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويؤدي شعائر الإسلام الظاهرة.
ويستدل أصحاب هذا الاتجاه بأحاديث صحيحة، منها قول النبي ﷺ: “من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم” ( رواه البخاري).
وكذلك حديث: “مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى” (متفق عليه). وفي رواية مسلم: “المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله”.
ويعكس هذا الاتجاه نظرة شمولية تقوم على وحدة الأمة الإسلامية، بغض النظر عن الحواجز الجغرافية والاعتبارات السياسية، مؤكدًا على البُعد الإيماني والروحي في تكوين الأمة المسلمة.
ومن خلال النظر في الأدلة والمقاصد الشرعية، يترجّح القول بانتماء الأقليات المسلمة إلى الأمة الإسلامية ما دامت محافظة على عقيدتها، عاملة بشريعتها، معتزة بدينها؛ إذ لا يمكن للعوامل السياسية أو الجغرافية أن تنقض رابطة الإيمان التي أثبتها النص الصريح، وجعلها أساس العلاقة بين المسلمين كافة.
ومما يؤيد هذا الرأي حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حيث قال: “اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن” (رواه الترمذي). ويعكس هذا التوجيه النبوي عمق الفهم الإسلامي لمفهوم الالتزام، الذي لا تحدّه الجغرافيا، ولا تُلغيه الظروف، بل يتأسس على المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الله تعالى في كل حال ومكان.
والرأي الأول، الذي اشترط الهجرة أو الإقامة في ديار الإسلام لانعقاد الموالاة والانتماء الكامل إلى الأمة، أصبح موضع إشكال في ضوء عدة اعتبارات، منها:
- تغيّر مفهوم الدولة: لم تعد “ديار الإسلام” و”ديار الكفر” مفاهيم تُطبق بحرفيتها كما في العصور السابقة، بل أصبحت الدول الحديثة كيانات مدنية قائمة على المواطنة والقانون، مع تفاوت في مساحة الحرية الدينية.
- الاندماج الإيجابي: كثير من الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية تساهم في نشر الإسلام، وتقديم صورته الحضارية، والدفاع عن قضايا المسلمين عالميًّا. وهو دور ريادي لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه.
- صعوبة تطبيق فكرة الهجرة: كثير من المسلمين لا يملكون الخيار الواقعي للهجرة، إما لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، فكيف يُشترط عليهم أمرٌ قد يتعذر تنفيذه؟
- الانتماء العقدي مقدم على الانتماء السياسي: الانتماء إلى الأمة الإسلامية يقوم على وحدة العقيدة، لا على وحدة الأرض أو الحكومة. وهو ما دلت عليه النصوص الشرعية الصريحة.
- أثر هذا الرأي على وحدة الأمة: تبنّي الرأي الأول قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المسلمين، ويُضعف أواصر الوحدة والرحمة بين أبناء الأمة الواحدة. وهو خلاف مقاصد الشريعة في توثيق روابط الأخوّة.
لذلك، فإن تبنّي الرأي الثاني، الذي يقول إن الأقليات المسلمة جزء أصيل من الأمة الإسلامية، يمثل الموقف المتوازن الذي يجمع بين النصوص الشرعية ومقاصدها، وبين واقع المسلمين في عصر تتجاوز فيه الروابط الدينية الحدود السياسية والاعتبارات الجغرافية.
في الصين، تحتل الأقلية المسلمة المرتبة الثانية في آسيا من حيث العدد بعد الهند، وتُقدّر نسبتهم بنحو 1.73% من إجمالي سكان البلاد، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.44 مليار نسمة
واقع الأقليات المسلمة العددي في العالم
تُظهر الإحصائيات المعاصرة أن الأقليات المسلمة تكوّن شريحة كبيرة من التركيبة السكانية للمسلمين عالميًّا، حيث يُقدَّر أن نحو 35% من مجموع المسلمين في العالم يعيشون كأقليات في حوالي 143 دولة من أصل 195 دولة في العالم المعاصر، منتشرة في ست قارات، وهذا يعكس حجم التوزيع الجغرافي الواسع للمسلمين خارج الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ومن جهة أخرى، يبلغ عدد الدول ذات الأغلبية المسلمة نحو 49 دولة، ما يعني أن بقية الدول تضم مجتمعات مسلمة تُعدّ أقليات، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. وتفاوت هذه الأقليات من حيث الحجم والتركيبة السكانية يُبرز أهمية دراستها وتفهم خصوصياتها.
فعلى سبيل المثال، تُعد الأقلية المسلمة في الهند من كبرى الأقليات الإسلامية في العالم، بل تُشكّل التجمع الثالث للمسلمين عالميًّا بعد إندونيسيا وباكستان من حيث العدد. فبحسب إحصاءات عام 2021، يُمثل المسلمون في الهند 14.2% من إجمالي سكان الهند، أي ما يقارب 200 مليون نسمة، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أنهم أقلية في بلد ذي أغلبية غير مسلمة.
وفي الصين، تحتل الأقلية المسلمة المرتبة الثانية في آسيا من حيث العدد بعد الهند، وتُقدّر نسبتهم بنحو 1.73% من إجمالي سكان البلاد، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.44 مليار نسمة. ويمثّل هؤلاء المسلمون مجموعة متنوعة من الأعراق، مثل قومية هوى والإيغور.
أما في الدول ذات التجمعات الإسلامية الصغيرة، فنجد أقليات لا يتجاوز عددها آلافًا قليلة، كما هو الحال في نيوزيلندا، حيث بلغ عدد المسلمين بحسب تعداد 2023 نحو 75.144 نسمة، يشكّلون 1.5% من إجمالي السكان. وعلى الرغم من صغر الحجم النسبي، فإن هذه الأقلية تتمتع بحضور ثقافي وديني فاعل نسبيًّا، ولها دور في تشكيل صورة الإسلام في المجتمع النيوزيلندي.
وهذه المعلومات تؤكد الحاجة الماسّة إلى فقه واقع معاصر، يُراعي هذه التباينات العددية والثقافية، ويُسهم في التعاون العلمي والدعوي الخيري لتلك الأقليات، بشكل يُعزز من قدرتها على الحفاظ على هويتها الإسلامية، وفي ذات الوقت الاندماج الإيجابي في مجتمعاتها الوطنية.
إن أول خطوة في تمكين الأقليات المسلمة تكمن في تحديد الأولويات الملحّة الخاصة بكل أقلية، وفق خصوصية وضعها المحلي؛ إذ إن ما يُعدّ أولوية في بلد معين، قد لا يكون كذلك في بلد آخر
أولويات الأقليات المسلمة
تُواجه الأقليات المسلمة في مختلف بقاع العالم نوعًا من التحديات المعقّدة والمشكلات متعددة الأبعاد، التي تؤثر بشكل مباشر على استقرارها واستمرارها، بل على بقائها أصلًا، فضلًا عن مساهمتها الفاعلة في محيطها الإنساني والثقافي.
هذه التحديات، التي تتفاوت طبيعتها وحدّتها بحسب السياق الجغرافي والسياسي والاجتماعي، تقف حائلًا دون نمو تلك الأقليات وازدهارها، وتعيق رقيّها وتطورها، وتحدّ من قدرتها على أداء رسالتها الحضارية والدينية.
ولا يمكن لأي أقلية مسلمة أن تحقق الاستقرار وتؤدي دورها بفاعلية إلا إذا وعت هذه التحديات، وسعت إلى معالجتها معالجة منهجية شاملة، سواء تعلّقت هذه التحديات بالمجال الديني كالتضييق على ممارسة الشعائر أو غياب المؤسسات الدينية، أو بالمجال السياسي كالتمييز أو ضعف التمثيل في مراكز القرار، أو الاقتصادي كالفقر والبطالة والحرمان من الفرص، أو الاجتماعي كالتمييز العنصري وصعوبات الاندماج، أو الثقافي والتعليمي كطمس الهوية، أو تهميش اللغة والدين في المناهج الرسمية.
ومن ثمّ، فإن أول خطوة في تمكين الأقليات المسلمة تكمن في تحديد الأولويات الملحّة الخاصة بكل أقلية، وفق خصوصية وضعها المحلي؛ إذ إن ما يُعدّ أولوية في بلد معين، قد لا يكون كذلك في بلد آخر. فبعض الأقليات قد يكون أول ما تحتاجه هو تأمين الحق في العبادة، بينما تحتاج أقليات أخرى إلى الاعتراف القانوني، أو إلى الدعم التعليمي والثقافي.
إن استشراف هذه الأولويات ووضعها في إطار منهجي يُعدّ ضرورة شرعية وواقعية لضمان بقاء الأقليات المسلمة، وتثبيت وجودها الحضاري، وتمكينها من أداء دورها في نشر قيم الإسلام، والإسهام في رفعة المجتمعات التي تعيش فيها، مع الحفاظ على هُويتها العقدية والثقافية ضمن معادلة توازن دقيقة بين الانتماء الوطني والانتماء الديني.
فما هي هذه الأولويات بشكل عام؟.. هذا ما نتناوله في مقالة آتية.